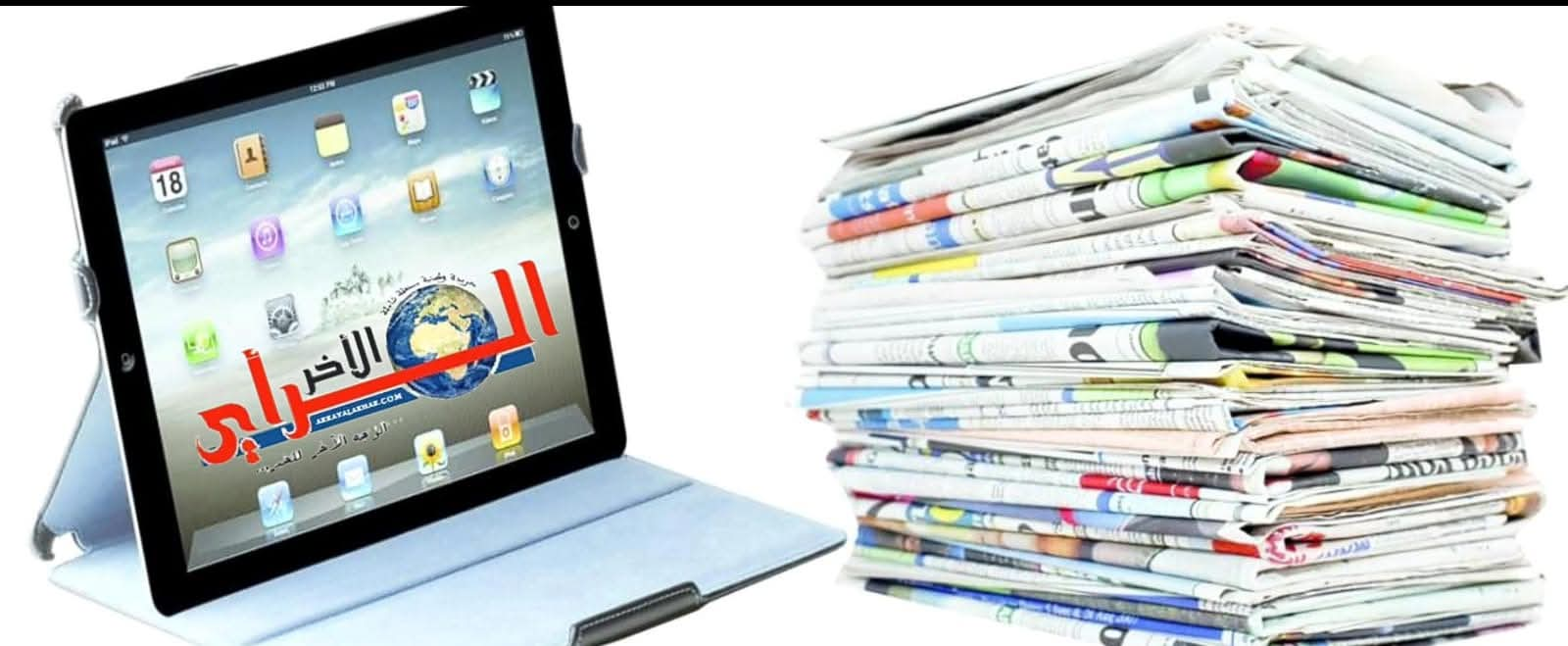على هامش قضية “بيع الماسترات”
أثارت إحالة أستاذ التعليم العالي على القضاء بتهمة تسليم شهادات جامعية مقابل عوض مالي، نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والمهنية، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إخضاع المتهم لوضعية الاعتقال الاحتياطي.
وعلى الرغم من أن الملف لا يزال في طور التحقيق، وانطلاقا من قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم بمقتضى المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الجدل القانوني والمهني يتجه نحو تقييم الأثار القانونية المترتبة عن هذه الواقعة – في حال ثبوتها قضائيا – لا سيما على علاقات الشغل ومصداقية الشهادات المعتمدة في الوسط المهني.
إن منح الشهادات الجامعية بالمغرب، سواء على مستوى الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، يخضع لإطار قانوني ومنهجي محكم، يتمثل أساسا في أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 (كما تم تعديله وتتميمه)، والذي يضبط شروط التسجيل والتأطير والبحث والمناقشة، كما يشترط المشرع توافر الضوابط البيداغوجية والإدارية، ومراعاة النزاهة الأكاديمية، بما يضمن المشروعية القانونية والقيمة العلمية للشهادات الممنوحة.
غير أن التساؤل المطروح يتمحور حول الحالة التي يثبت فيها قضائيا أن شهادات جامعية مُنحت دون استيفاء المتطلبات القانونية أو الإدارية المنصوص عليها.. عندئذ تصبح هذه الشهادات محض شك وغير مشروعة، وتتعرض لانتقاص المصداقية، بل وقد تفقد صحتها القانونية، مما قد تترتب عنه أثار جسيمة على المستويين المهني والقانوني.
من هذا المنطلق، نثير جملة من التساؤلات القانونية والإجرائية ذات الصلة:
1) هل تملك المقاولات الوطنية آليات للكشف عن الشهادات غير المشروعة أو المزورة ؟
في هذا السياق، نتساءل عن مدى توفر المقاولات الوطنية، وخصوصا في القطاع الخاص، على آليات فعالة للتأكد من مدى صحة الشهادات العليا التي يدلي بها المرشحون عند التشغيل؟ وهل توجد قاعدة تشريعية أو إدارية تلزم المشغل بالقيام بهذا النوع من التحقيقات ؟
لكن، أمام غياب منصة رسمية موحدة يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة الشهادات الجامعية، يجعل المقاولات في وضع هش عند إدلاء المرشحين بشهاداتهم عند التشغيل أو عند مطالبة الأجير المشغل بالترقية في الرتبة والدرجة والمنصب بسبب حصوله على الشهادة الجامعية التي تسمح له بذلك.
وهو ما يفرض على السلطات العمومية التفكير الجدي في خلق نظام معلوماتي مركزي للمصادقة على الشهادات، أي ضرورة إرساء آلية وطنية للمصادقة على الشهادات أسوة ببعض الدول كفرنسا، التي تعتمد منصة إلكترونية للمصادقة على الشهادات العليا.
وفي تجربة واقعية، شهدتها إحدى المقاولات خلال تسعينات القرن الماضي، طالبت الإدارة الجامعة بالتأكد من صحة الشهادة الجامعية لأحد أجرائها، فجاء رد الجامعة أن الشهادة غير مسجلة، مما دفع الأجير إلى تقديم استقالته طوعا، بعد استدعائه من قبل الإدارة وإخباره بموضوع شهادته، وتم طي ملفه دون متابعته قضائيا.
2) كيف يمكن للمشغل التعامل قانونيا مع أجراء اتضح لاحقا أن شهاداتهم غير مشروعة أو مزورة ؟
في حال ثبوت ذلك بموجب تحقيق إداري أو حكم قضائي نهائي، يمكن تصور عدة سيناريوهات قانونية: فتح تحقيق داخلي بناء على معطيات جديدة؛ مطالبة الأجير باسترجاع الفارق المادي الناتج عن الشهادة غير السليمة؛ فصل الأجير استناداًإلى خطأ جسيم ناتج عن الغش أو التدليس.
3) ما هو موقع مدونة الشغل من هذه الإشكالية ؟
رغم غياب نص صريح، فإن المادة 39 من مدونة الشغل، التي تورد الأخطاء الجسيمة على سبيل المثال لا الحصر، تتيح للمشغل اعتبار تقديم شهادة غير سليمة خطئا جسيما، خصوصا إذا ثبت أن الحصول عليها تم خارج الضوابط الأكاديمية أو بمقابل مالي.
كما يمكن اعتبار تقديم شهادة غير سليمة عند التشغيل أو بمناسبة طلب الترقية، صورة من صور الغش أو التدليس، ما دام هذا السلوك يؤثر جوهريا على إرادة المشغل عند إبرام عقد الشغل أو تجديده أو عند ترقيته. وفقا لمقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، يعتبر التدليس سببا لإبطال العقد متى كانت الحيل المستعملة على درجة من الجسامة بحيث لو علم بها الطرف الآخر لما أبرم العقد.
وبناء عليه، فإن الإدلاء بشهادة غير مشروعة، بعد الحصول عليها خارج المساطر القانونية (مقابل أداء مالي)، يعد غشا يفسد الرضى، ويشكل تدليسا جوهريا يبرر إنهاء علاقة الشغل.
كما يمكن أن يصنف هذا الفعل ضمن “خيانة الأمانة”، المبرر للفصل، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، نظرا لما يترتب عنه من إضرار بثقة المشغل وبأسس العلاقة الشغلية.
المبدأ القانوني
خيانة الأمانة تشمل أي تصرف ينطوي على خداع يمس الثقة بين الأجير والمشغل.
وتطبيق هذا المبدأ: إن تقديم وثيقة مشكوك في صحتها، أو غير مشروعة أو مزورة، والمعني بالأمر على بينة من ذلك، سواء عند التشغيل أو من أجل الحصول على ترقية، يعد خيانة للأمانة، لأنه يضلل المشغل ويؤثر على قراره التعاقدي.
وفي حالة ثبوت أن الشهادة المدلى بها مزورة، دون أن يتم الاستناد إلى الفصل 361 من القانون الجنائي، الذي يجرم تزوير الشهادات واستعمالها، ولم يتم تحريك الدعوى العمومية ضد الأجير، فإن الاستعمال المدني لتلك الشهادة يمكن أن يشكل في حد ذاته أساسا للفصل التأديبي، بناء على خطأ جسيم ناتج عن الإخلال الجسيم بالثقة والمصداقية.
في ضوء ما سبق، يثار سؤال قانوني جوهري يسترعي انتباه المشغلين والمهنيين في تدبير الموارد البشرية: هل يمكن للمشغل اتخاذ قرار بفسخ عقد الشغل، أو المطالبة باسترجاع المنافع المادية، في حالة ثبوت أن الأجير أدلى بشهادة مشكوك في صحتها أو تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو مزورة ؟
وللإجابة عن هذا السؤال، فمن الناحية القانونية، نعم، يتوفر المشغل على جملة من الآليات التي يمكن تفعيلها، شريطة احترام الضمانات والإجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل، ويمكن تلخيصها كالتالي:
• إمكانية فصل الأجير من العمل دون تعويض: إذا ثبت أن الشهادة مزورة أو غير قانونية، يمكن اعتبار ذلك خطئا جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل دون إشعار أو تعويض، استنادا إلى مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، مع ضرورة احترام مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62.
غير أنه إذا كانت المادة 39 من مدونة الشغل لا تنص صراحة على “الغش/التدليس”، فإن هذا لا يمنع المشغل من إمكانية الاستناد إلى الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتبر أن التدليس يكون موجبا لفسخ العقد متى تبين أن الحيل المستعملة التي استعاذ بها أحد المتعاقدين على درجة من الجسامة، بحيث لولاها لما قبل الطرف الآخر التعاقد.
• إرجاع الأجير للتعويضات المستفاد منها: يحق للمشغل، إذا توافرت أركان المسؤولية، أن يطالب الأجير بتعويض عن الضرر، خصوصا فيما يتعلق بالأجور التي صرفت أو الترقيات التي منحت له، بناء على شهادة تفتقد للمشروعية الأكاديمية أو القانونية.
• إبطال المزايا والامتيازات: يمكن للمشغل إعادة النظر في الترقيات أو الامتيازات المهنية التي حصل عليها الأجير بناء على الشهادة الجامعية واعتبارها غير قائمة، متى ثبت أن الأساس الذي بنيت عليه غير سليم.
وفي جميع الحالات، تبقى سلطة محكمة الموضوع حاسمة في تكييف الفعل المنسوب للأجير، وتحديد ما إذا كان يشكل خطئا جسيما، في حالة النزاع، كما تبقى للمقاولة صلاحية فتح تحقيق داخلي واتخاذ التدابير المناسبة بناء على معطيات موضوعية، شريطة احترام الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا.
ختاما، بينما تظل العدالة وحدها الجهة المخولة بإدانة الأشخاص أو تبرئتهم، فإن مسؤولية أرباب العمل والمشرع والإدارات الجامعية، تكمن في تقوية الثقة في الشهادات الجامعية، وضمان تكافؤ الفرص داخل سوق الشغل، واحترام مبدأ الجدارة والاستحقاق، وهي مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل.
ولا تفوتني الفرصة لتقديم بعض المقترحات العملية للمقاولات وتوصيات تشريعية تنظيمية في هذا الصدد، في حالة ثبوت أن الشهادات الممنوحة لا تخضع للشروط والمساطر القانونية والإدارية المنظمة بمقتضى القانون 01.00 ولا إلى مرسوم 2.04.89 كما وقع تغييره وتتميمه.
أولا: مقترحات عملية للمقاولات
1) مراجعة ملفات الشهادات الجامعية للأطر العاملة بالمقاولات، خاصة في الفترات الزمنية المشمولة بالشبهات؛
2) مراسلة الجامعات والمؤسسات المانحة للشهادات، قصد التحقق من صحتها عبر قنوات رسمية؛
3) اعتماد تصريح بالشرف، بشأن صحة الشهادات المدلى بها عند التشغيل أو عند المطالبة بالترقية؛
4) تحيين ملفات الأجراء الحاليين بهدوء وشفافية؛
5) فتح مساطر تأديبية عند الاقتضاء، مع احترام الضمانات القانونية.
ثانيا: توصيات تشريعية وتنظيمية
1) إحداث سجل وطني موحد للشهادات الجامعية؛
2) إحداث منصة وطنية للتحقق من صحة الشهادات؛
3) تطوير آليات التصديق الإلكتروني للشهادات؛
4) إدراج مقتضى خاص في مدونة الشغل، لتجريم تقديم الشهادات غير السليمة؛
5) تحفيز المقاولات المنخرطة في آليات الشفافية والتحقق.