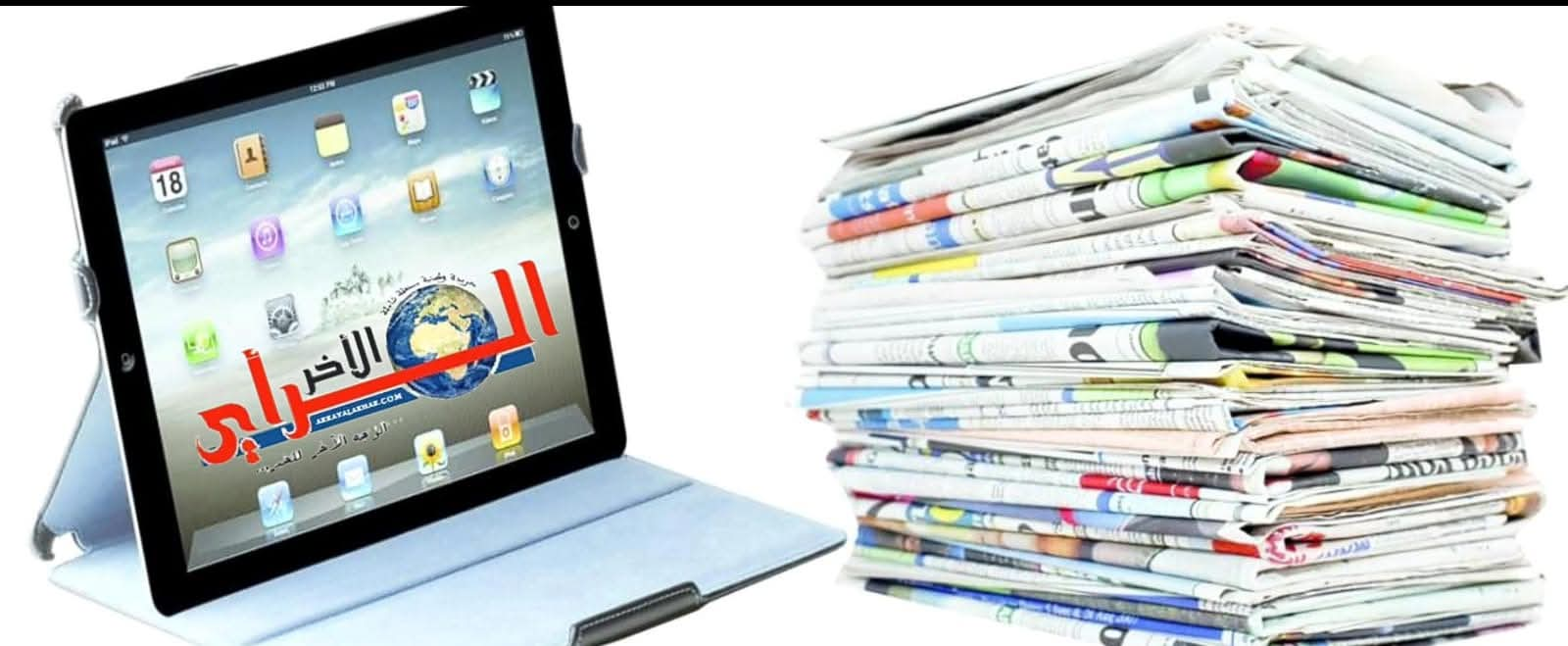فيلم “ران كولو دونيت”، هو عمل درامي أمازيغي ناطق بتشلحيت، من سيناريو وحوار الفنان القدير محمد أباعمران، وإخراج فاطمة علي بوبكدي، .
يتجاوز هذا الفيلم بعده السردي العادي إلى طرح رؤية فلسفية رمزية عميقة، تسائل البنية الاجتماعية والدينية في المجتمع الأمازيغي، من خلال قصة تتسم بالبساطة الظاهرة، والتعقيد الرمزي في عمقها. ولذلك تستند هذه الورقة إلى مقاربة أنثروبولوجية رمزية وتأويلية ، لفهم دلالات هذا العمل وإنتاج معانيه المستترة من خلال الشيفرات الثقافية والدينية والاجتماعية التي يتضمنها. عبر مشاهد تحي على الهشاشة القيمية أمام فتنة ” الدونيت” ، تلك التي تجسد في هيئة أنثى، لكنها في العمق مجاز للدنيا، بكل إغراءاتها وتناقضاتها.
يحاكي الفيلم قصة “الدونيت”، شابة جميلة تقتحم فضاء قرويا أمازيغيا تسوده تعايشات سلمية بين اليهود والنصارى والمسلمين، في انسجام يحاكي نوعا من الطوباوية الاجتماعية. لكنها ما تلبث أن تفجر – أي الدونيت- هذا الانسجام وتبعثر تماسكه الداخلي، بمجرد حضورها المثير. و”الدونيت” لا تحتاج إلى سلاح أو خطابة، بل فقط إلى حضورها الأنثوي المتوهج، كأن جمالها هنا يبدو فاعلا رمزيا يتجاوز البعد الجمالي السطحي، ليغدو حاملا لقوة سحرية تربك التراتبيات الرمزية القائمة، وتحدث شرخا بين المستويات القيمية: بين المقدس والمدنس، بين السلطة والرغبة، بين مظاهر التدين والنزوع الغرائزي. فبالتالي نحن أمام شخصية متعالية على الواقع المألوف، تفرض منطقها الخاص، وتعري هشاشة البنية القيمية التي يتغنى بها المجتمع، وتسائل جدلية الثابت والمتحول في البنى الرمزية الحاكمة.
تغوي “الدونيت”، تباعا، الرعاة الثلاثة: الراعي المسلم “بيكا”، ثم الراعي النصراني “جورج”، والراعي اليهودي “باعكا”، وكلهم من طبقات هامشية، تجسد العمل اليومي والكدح. بحيث تقابل هؤلاء في الأول وتوهم كل واحد منهم بأنه سيكون زوجها المستقبلي، وتعدهم بالثراء وفك ضيق الحال، وتمنحهم وعدا مبهما بعبارة واحدة : “إن شاء الله”، وعود لا تتحقق، أشبه بالمراوغات التي تدغدغ آمال البسطاء دون أن تمنحهم ما يريدون. يتصارع الرعاة، يتصاعد التوتر عندما تصل أخبار العراك إلى مشغلي الرعاة: ” دادا الفاهيم” ( مسلم، شيخ القبيلة)، و “موريس ” ( تاجر نصراني)، وموشي ( حرفي يهودي). يحاول هؤلاء فض النزاع بين رعاتهم، غير أنهم يقعون بدورهم تحت تأثير جمال ” الدونيت”، ويتحولون من قضاة إلى متصارعين. وتستمر العدوى حين يلجأ الجميع إلى رجال الدين الثلاثة: الفقيه المسلم، والحخام اليهودي، والراهب النصراني، لعلهم يجدون حلا شرعيا لهذا الافتتان الجماعي. غير أنهم انجرفوا هم الاخرين في صراع غرائزي على ” الدونبت”، التي لن تختار أحدا منهم في النهاية، بل تركض وتختفي، تاركة الجميع في حيرة وانكسار.
توظيف هذا التسلسل الطبقي لم يأتي من محض الصدفة، بل يشكل بنية سردية مقصودة، تبرز كيف تتغلغل عدوى الرغبة كظاهرة اجتماعية غير قابلة للحصر أو الردع. فالرغبة لا تظل حكرا على طبقة بعينها، ولا تحدد وفق الحاجات البيولوجية أو الاقتصادية الصرفة، بل تنتشر كعدوى رمزية، تتكثف حول موضوع مشحون بالدلالة، مثل “الدونيت”.
وهنا تستقيم أطروحة بيير بورديو التي ترى ضمنيا أن الرغبة لا تقاس بالحاجة، بل بالرمز الذي تحمله الأشياء، فبالتالي يفكك بورديو التصور الاختزالي للرغبة باعتبارها استجابة لحاجة فطرية أو مادية. فالرغبة، في نظره، ليست نابعة من عوز طبيعي، بل تبنى اجتماعيا وثقافيا، وتتغذى من المعاني الرمزية التي تمنحها الجماعة للأشياء أو الأشخاص. وبمعنى أخر، ما نرغب فيه ليس الشيء في حد ذاته، بل القيمة التي نعتقد أن الآخرين يضفونها عليه، أو المرتبة الرمزية التي يمثلها داخل الحقل الاجتماعي.
وفي سياق هذا العمل، لا يكمن سحر “الدونيت” في جمالها فقط، بل في الرمزية الكامنة في جسدها كامرأة-دنيا، تمثل الوجاهة، والمتعة، والسلطة، والاختراق الاجتماعي. وهذا ما يجعل الفقير يتوق إليها كما يتوق إليها الغني، ويجعل المتدين يتعثر أمامها كما يتعثر غيره، لأن الرغبة هنا مشروطة بمنطق التماهي والتنافس الذي ينتجه الحقل الرمزي، تماما كما أوضح بورديو في نظريته عن “الذوق” و”التمييز الطبقي”.
هكذا، يعرّي الفيلم آليات الرغبة داخل المجتمع، ويظهر كيف أن القيمة تصنع في المجال الرمزي، لا في الحاجات الطبيعية. فـ”الدونيت” لا ترغب لكونها فقط امرأة، بل لأنها محملة بكل التمثلات الاجتماعية حول “الدنيا” وفتنتها، ومن ثم تصبح الرغبة فيها فعل انخراط رمزي في لعبة الهيمنة والتمايز.
تمضي الأحداث في تصعيد درامي دقيق، يكشف كيف تتحول “الدونيت” إلى مركز الثقل الرمزي الذي يتمحور حوله الجميع، وتتعرى من خلالها البنية القيمية للمجتمع، فبالتالي تحليل هذا العمل من منظور أنثروبولوجي رمزي يستدعي، أولا استحضار المفهوم الذي صاغه كليفورد غيرتز بحيث يرى أن الثقافة هي شبكة من المعاني التي ينسجها الإنسان بنفسه ويقع فيها. هذه الرؤية تساعدنا على فهم كيف تتحول “الدونيت”، باعتبارها تمثيلا رمزيا للدنيا، إلى ذروة المعنى الثقافي داخل هذا البناء السردي، فهي ليست فقط جسدا مغريا، بل محركا لأسئلة وجودية حول السلطة، الرغبة، القيم، والغاية.
من الراعي البسيط إلى رجل الدين، من الفقير المهمش إلى الغني المتنفذ، الجميع ينزلق في فخ الرغبة التي تجسدها “الدونيت”. وتتحول الأنثى هنا إلى مرآة كاشفة، لا تغوي فقط، بل تكشف زيف ادعاءات التماسك الأخلاقي، وتفضح هشاشة البنية الرمزية التي يتكئ عليها المجتمع في تحديد الفضيلة والضبط الأخلاقي.
وهكذا، تصبح “الدونيت” استعارة مكثفة للفتنة التي تهز أركان الجماعة، وتعيد ترتيب علاقتها بالقيم، بالسلطة، وبالآخر. فكل انزلاق نحوها ليس انحرافا فرديا، بل تعبير عن اختلال جماعي أعمق، يخص النسيج الثقافي نفسه الذي نسجت منه “الشبكة” التي يقع فيها الجميع، حسب تعبير غيرتز.
هذا السرد الدرامي الذي يبدو بسيطا يخفي خلفه رمزية كثيفة. ف “الدونيت” ليست مجرد شابة جميلة، بل تمثل صورة مجازية للدنيا، بما تحمله من غواية، وإيهام، ووعود لا تتحقق. وقد تم تجسديها على هيئة انثى لا شيئا آخر، لكون المخيال الجمعي في الثقافة الأمازيغية كما في معظم الثقافات، يربط بين الأنثى والإغواء، وبين الجسد الأنثوي ومواطن الفتنة. المرأة هنا ليست مجرد كائن بشري، بل رمز للمتعة، للثروة، للخصوبة، وللفتنة في آن واحد. اختيار المرأة كرمز للدنيا يحيل إلى تصور ديني متجذر يربط بين حب الدنيا والشهوة، ويضع هذا الحب في إطار الإدانة الأخلاقية والروحية، حيث ينظر إلى الدنيا بوصفها زائلة، خداعة، مفسدة للمجتمع وللقيم الروحية.
ان التمثيل الرمزي للدنيا بالمرأة ، يمنحها ملامح ساحرة ومراوغة، في إحالة إلى التراث الأخلاقي والديني الذي لطالما ارتبط فيه تمثيل الدنيا بصورة أنثى فاتنة تغوي المؤمن، وتدفعه نحو الهلاك. هذا التصور ليس بريئا، بل يستند إلى خلفية ثقافية تتقاطع فيها الرؤية الأخلاقية مع الرؤية الذكورية، حيث يتم تحميل الأنثى عبء رمزي يتجاوز جسدها إلى معنى يتخلل الفضاء الاجتماعي بكامله. ف ميرسيا إلياد يرى أن الرموز ليست مجرد إشارات بل هي بنى ذهنية تعطي للعالم دلالة، و”الدونيت” هنا ليست فقط امرأة، بل بنية رمزية كاملة.
يستند هذا العمل إلى البناء الرمزي الكثيف الذي يجعل منه نصا أنثروبولوجيا قبل أن يكون دراميا. فالدين، والطبقة، والسلطة، جميعها تنهار أمام إغواء الدنيا. الرعاة يمثلون الطبقة الدنيا، المرتبطة بالبساطة والتقشف وسوء الحال، بينما المشغلون يمثلون الطبقة الغنية ذات النفود الاقتصادي، أما رجال الدين، فيمثلون القيم والسلطة الرمزية، الروحية. غير أن الجميع ينصهر أمام جمال ” الدونيت”، ما يعكس تهافتا بشريا عاما نحو المصلحة، والرغبة في التملك، والاغتناء، والخلاص الفردي. كل شخصية تمثل موقعا اجتماعيا ودينيا محددا، لكنها تسقط في الفخ نفسه، بما يشير إلى ان الرغبة لا تعترف بالتراتبية. وكأن هذا العمل الابداعي يعيد إنتاج المفاهيم المرتبطة بالقيم، “فحين تصبح القيم خاضعة للرغبة، تنهار الحقيقة”.
هذه المقولة تفكك مفهوم الحقيقة الثابتة، لتظهرها كـ”قيمة مصطنعة” تنهار ما إن تتدخل فيها الرغبة، تلك القوة الحيوية التي تحكم الإنسان من الداخل. فالقيم ليست سماوية أو مطلقة، بل هي مشروطة بإرادة الحياة والسلطة والتملك، ما يعني أن الحقيقة التي يتغنى بها المجتمع ليست إلا تمثلا هشا، سرعان ما يسقط أمام اختبار الرغبة.
وفي سياق هذا العمل، عندما تصبح الرغبة هي المحرك الرئيسي للسلوك، فإن الدين يتحول إلى قناع، والسلطة إلى وسيلة، والقيم إلى واجهات شكلية. وهنا تنهار الحقيقة بمعناها الاجتماعي والديني، لأن معيار الفعل لم يعد القيمة أو المبادئ، بل نزوة الرغبة وقوة الإغواء، كما تجسدها “الدونيت”. وبهذا المعنى، يعيد الفيلم تفكيك خطاب الفضيلة من الداخل، ويكشف كيف يمكن للجمال، والأنوثة، والرمز، أن يتحول إلى قوة هدم بناءة، تكشف زيف المقولات الكبرى، وتعيد مساءلة صدقيتها.
“الدونيت” تعد الجميع، ثم تختفي، في صورة رمزية شديدة الدلالة: باعتبارها مخلوق فوق الواقع، لا تمسك ولا تحتوى، فهي تعد الجميع وتخون الجميع، تسحر الجميع وتهرب منهم جميعا، بما يشبه الحلم الذي لا يتحقق ، لأنها تراوغ، تغوي، وتفلت في اللحظة الحاسمة. هنا، تتجلى البصمة الرمزية للفيلم: الدنيا واحدة، لكن الجميع يتوهم أنه قادر على امتلاكها. هذا التوهم هو ما يجعل البشر في صراع دائم، لا بسبب الحاجة، بل بسبب الوهم. إنها قراءة متأملة في الطبيعة البشرية، تستدعي الفشل الوجودي الذي يطارد الإنسان في سعيه نحو السعادة المؤجلة. واختفاؤها في النهاية يمثل نهاية السعي العبثي وراء الدنيا، ويعيد إنتاج المقولة الفلسفية القديمة ” الدنيا كالحسناء الفاتنة، تراوغ الجميع ولا تكون لأحد”.
على المستوى البصري، اعتمدت المخرجة فاطمة بوبكدي، على تقنيات بسيطة ومركبة في آن، من خلال تصوير مشاهد القرية في إطار طبيعي مفتوح، يجعل من القرية فضاء كونيا لا مكانا محدودا. التنوع الديني واللغوي الذي يجمع اليهودي والنصراني والمسلم، يؤسس لفكرة التعدد الثقافي في الجنوب المغربي، ويستحضر الذاكرة الجماعية المشتركة، التي وإن تجاوزها الواقع اليوم، لا تزال حاضرة في وجدان الناس. غير أن هذا التعايش، الذي يبدو متينا، يتهاوى أمام أول امتحان للغريزة وحب الملذات، ما يجعل من هذا الفيلم تأويلا نقديا للحظة الحداثية، التي تتغلب فيها الفردانية على الجماعة.
كما نلاحظ اعتمادها على الصورة كقناة رمزية لا تقل أهمية عن الحوار. فالقرية ليست مجرد خلفية، بل فضاء أنثروبولوجي غني بالعلامات: المعبد، المسجد، الكنيسة، الطريق… كلها أماكن تحولت إلى فضاءات دلالية تحمل رسائل ضمنية. فنحن أمام خطاب بصري حافل بالدلالات، حيث لا توجد مشاهد مجانية، بل كل شيء محمل بالمعنى. حتى الملتقى الطرقي الذي تتواعد فيه الشخصيات هو رمز لملتقى المصائر، واختبار النوايا، وامتحان الذات أمام الإغواء. فبالتالي؛ هو رمز للتقاطع بين الخيارات، للمفترق القيمي، وللضياع الأخلاقي.
كما أن استعمال اللهجات والملابس والطقوس الخاصة بكل دين، لم يكن مجرد تنويع ثقافي، بل تأكيد على وحدة المصير الإنساني، مهما اختلفت المرجعيات. والنتيجة: كلهم يغوون، كلهم يتصارعون، وكلهم يخذلون. وكأن الفيلم يصرخ: “الدنيا واحدة، والعبرة ليست في من يملكها، بل في من لا يفتتن بها”. تظهر “الدونيت” كذلك البعد الخادع للسلطة، حيث لا شيخ القبيلة ولا الفقيه ولا التاجر، استطاعوا أن يوقفوا فتنتها. وهذا يقود إلى نقد لاذع للسلطة الأخلاقية في المجتمعات التقليدية، التي تدعي الحصانة القيمية، لكنها في الواقع واهية أمام فتنة الجمال والمصلحة. في لحظة التعري الرمزي هذه، تنهار كل الأسوار، ويتحول الجميع إلى رهائن للرغبة.
ليس غريبا إذا أن تكون نهاية الفيلم مفتوحة، وإنما ظلت متمسكة بأسئلة مفتوحة: هل كانت ” الدونيت” حقا فتاة من لحم ودم أم رمزا محضا؟ هل كان هذا السعي خلفها يعكس أزمة وجودية عميقة داخل الإنسان؟ لماذا أخفقت كل المرجعيات – الدينية والاجتماعية والاقتصادية- في مقاومتها؟ هذا الانفتاح على التأويل يجعل من فيلم ” ران كولو الدونيت” عملا رمزيا بامتياز، يحق للمتفرج أن يراه أسطورة حديثة، أو نقدا اجتماعيا لاذعا، أو مرآة روحية لمجتمع مأزوم.
فبالتالي هذا العمل ليس فقط فيلما، بل مرآة رمزية عميقة لانفعالات الإنسان، وافتتانه بالوهم، وسقوطه في فخ الرغبة. هو نص بصري يمكن تأويله من عدة زوايا: وجودية، دينية، سوسيولوجية، وجمالية. فيلم يعيد بناء الحكاية الأزلية: حكاية السعي نحو “الدونيت”، التي لا تكون إلا سرابا لمن أراد امتلاكها، لكنها قد تكون خلاصا لمن رأى فيها مجرد مرور.
بهذا المعنى، يمكن القول إن “ران كولو دونيت”، هو من أرقى ما أنتج في السينما الأمازيغية من حيث التوظيف الرمزي للمخيال الجمعي، ومن حيث جرأته على تعرية بنى السلطة الرمزية والدينية والاجتماعية. إذ لا يقرأ كسردية خطية، بل كنص أنثروبولوجي مفتوح على التأويلات، يفكك البنية الرمزية للمجتمع الأمازيغي من خلال قصة بسيطة الشكل، عميقة المحتوى. يوظف الفيلم الأنثى كرمز كوني للدنيا، ويعري تناقضات المجتمع، ويكشف هشاشة الإنسان أمام الوهم. فيلم يشاهد بالبصر، ويقرأ بالبصيرة، ويؤول بالعقل، ويستعاد بالقلب.
أريناس نعيمة موحتاين